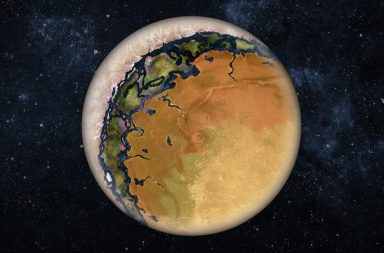المكوّنات الكهربائية الموفّرة للطاقة التي تسمى الصمّام الثنائي الباعث للضوء (ليد-Led) كانت فيما مضى نعمةً للبيئة، لكنّ الباحثونّ اكتشفوا أنها تساهم في زيادة مستويات التلوّث الضوئي، والمشكلة المتنامية للتلوث الضوئي لا تُظهر أيّ علاماتٍ على التباطؤ، والتي هي بالمناسبة أخبارٌ سيّئة للمنظومة البيئية لدينا ولصحتنا كذلك.
ويعدّ الجزء الكبير من المشكلة هو أننا لا نفكر في الضوء بنفس الطريقة التي ننظر بها إلى الهباء الجويّ الضار أو السوائل السامّة. عندما نخترع تكنولوجيا جديدة باعثةً للضوء، لا نفكر بتاتًا في التكلفة المحتملة للبيئة، نفكّر فقط في إنهاء الظلام مع المصابيح، لذلك فالنتيجة واضحة كوضوح الشمس، عالمنا لديه ظلامٌ أقل من أي وقت مضى.
قادَ الفيزيائي كريستوفر كايبا من معهد (جي.إف.زي) الألمانيّ لأبحاث علوم الأرض، دراسةً باستخدام بيانات الأقمار الصناعية للتحقيق في مدى سطوع ليالينا، وقد قال كريس: «سنقومُ بإضاءة شيء لم نكن نضيئه من قبل، مثل مسار دراجة في متنزّه، أو قسم من الطرق السريعة الرائدة خارج المدينة التي لم تكن مضاءة في الماضي»
يستخدم الباحثون مصطلح (تأثير انتعاش) لإظهار كيف أنّ الاستخدام الفعّال للطاقة يترك لنا المزيد من المال الذي نضعه بكل بساطة مرة أخرى في صناعة المنتج.
يمكننا أن نرى نفس التأثير في نهجنا لشراء السيارات، كفاءة الوقود (شكل من الكفاءة الحرارية)، تؤدّي إلى المزيد من الوقود للقيادة لمسافات أطول، بدلًا من انخفاض في إجمالي استهلاك الطاقة.
التلوث الضوئي ليس مصدر قلق جديد، خاصة بين علماء الفلك، وعلماء البيئة.
نَمَتْ الإضاءة في الهواء الطلق بمعدل 3 إلى 6 في المئة سنويًا في النصف الثاني من القرن 20، كمؤشر على نهاية الليل كما كنّا نعرف في أجزاء كثيرة من العالم، وكان علينا الاعتماد على التقديرات والافتراضات الإحصائية لمعرفة مدى سوء ذلك.
وقد قدّمت تكنولوجيا الأقمار الصناعية مؤخّرًا بيانات دقيقة وموثوق بها بما فيه الكفاية لمراقبة المشكلة بالتفصيل، واستخدم الفريق المعلومات التي تم جمعها بواسطة مقياس الإشعاع الذي يلقب بجناح الأشعة تحت الحمراء للتصوير الإشعاعي المرئي (ف.ي.ر.س) الخاصّ بالإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (إدارة أمريكية مهتمة بشؤون علم المحيطات والطقس والمناخ المتعلق بالغلاف الجوي).
قام الباحثون بتحليل النمو في التلوث الضوئي بين عامي 2012 و2016، وفي المتوسط ازدادت مساحة المنطقة المضاءة في الليل بنحو 2.2 في المائة سنويًّا، وكانت المناطق المضاءة بشكل مستمر حوالي 2.2 في المئة أكثر إشراقًا كل عام، وحدث النمو في معظم أنحاء أمريكا الجنوبية وأفريقيا وآسيا، في حين لوحظ انخفاض في الإضاءة في معظم المناطق التي مزقتها الحروب، مثل سوريا واليمن.
وقد استقرّت الإضاءة في عدد قليل من البلدان، معظمها تلك التي كانت مضاءة ببراعة بالفعل.
إذا كان كل هذا يبدو سيء، فمن المرجح أن يكون أسوأ قليلًا من الواقع، لأنّ بيانات الأقمار الصناعية لم تتمكن من الكشف مباشرة عن أطوال الموجة الزاهية التي تنبعث منها العديد من أجهزة (ليد).
وقال كريس: «يمكننا القول بثقة عالية إلى حد ما على الرغم من أننا لم نقس في الأقمار الصناعية زيادة في هذه البلدان، فهي تكاد تزدادُ بالتأكيد في السطوع من حيث الكيفية التي ينظر بها البشر إلى الضوء».
نهاية الطيف المرئي التي هي أكثر قربًا من ضوء النهار، لذلك حتى لو كنّا نفترض أن اللّمعان العام لم يزدَد في البلدان التي كانت تحل محل المصابيح القديمة مع تقنية (ليد)، كنا لنشعر بالليل كأنه نهار.
ومن الثابت أن هذا الفيضان من الضوء الأزرق له تأثيرٌ خطيرٌ على صحتنا ورفاهيّتنا، كما أنّه يعبث مع الحياة البرية، قد لا تهتمّ كثيرًا ببضعةٍ من الأشهر التي قد تصاب بها بدوار بسبب الأضواء، لكنّ الأبحاث تبين أن إضاءة (ليد) يمكن أن يكون لها آثار عميقة على مجموعة من أنواع النباتات والحيوانات.
لذلك فإنه ينبغي علينا أن نتذكر أن هناك نوع آخر من التلوث نحن بحاجة إلى أن نشعر بالقلق إزاءه، عندما يتعلق الأمر بإيقاف هذا الضوء.
- ترجمة: رضا الكصاب
- تدقيق: لؤي حاج يوسف
- تحرير: ناجية الأحمد
- المصدر