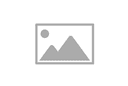يرى فريق من الفيزيائيين أن واقعنا نوع من الهولوغرام الكوني، إذ إن الزمكان والجاذبية ليسا سوى بعض من المظاهر الناتجة عن كون ثنائي الأبعاد. يعتقد هؤلاء العلماء أن ميكانيكا الكم قد تعمل في إطار بُعدي أقل، ما يمنح البشر وهمًا بوجود كون ثلاثي الأبعاد.
يغير هذا التصور من طبيعة الواقع كما يدركه البشر، متضمنةً مفهومي الجاذبية والزمن، إلا أن مبدأ الهولوغرام لا يخلو من أوجه القصور، من أبرزها افتراض وجود حدود واضحة للكون، وهو أمر لم يُرصد له أي دليل تجريبي.
مع تعمق الفيزياء النظرية في طبيعة الواقع، يوجد العديد من الأسئلة المطروحة، فهل تُقدم هذه الرؤى النظرية الأخيرة كشفًا حقيقيًا عن طبيعة الواقع؟ أم أنها مجرد أدوات رياضية لحل معضلات فيزيائية معقدة؟ وما الحد الفاصل بين ما هو من ابتكار الخيال الرياضي وما هو منتج للكون نفسه؟
الثقوب السوداء قد تكون الدليل:
بدأت المشكلة من تلك الكيانات الغامضة في الكون: الثقوب السوداء.
ظاهريًا، تبدو الثقوب السوداء بسيطة، فالأشياء تسقط فيها ولا تعود أبدًا، إذ تختفي جميع المعلومات عن تلك الأشياء وراء أفق الحدث بلا عودة.
لكن في سبعينات القرن الماضي، اكتشف الفيزيائي الشهير ستيفن هوكينغ أن الثقوب السوداء ليست سوداء تمامًا، فهي تطلق كمية ضئيلة من الإشعاع، ما يؤدي إلى تبخرها تدريجيًا بمرور الوقت.
إلا أن هذا الإشعاع لا يحمل أي معلومات عن المادة التي سقطت في الثقب الأسود، ما يخلق مفارقة معلوماتية مزعجة مفادها: «تختفي المعلومات إلى الأبد في تناقض صارخ مع مبدأ حفظ المعلومات في ميكانيكا الكم».
في هذا السياق، تعني المعلومة مجموعة الخصائص الكاملة لجميع الجسيمات التي سقطت داخل الثقب الأسود، أي كل ما هو مطلوب لإعادة بناء الأجسام الأصلية.
بدلًا من ذلك، فإن ما يخرج من الثقب الأسود -بسبب إشعاع هوكينج- هو مجرد مجموعة من الجسيمات العشوائية، ومن غير الممكن تحديد ما سقط فيه بناءً على الإشعاع المنبعث.
ظهر دليل رئيسي في العقود التي تلت اكتشاف هوكينج الاستثنائي: إحدى طرق قياس كمية المعلومات هي عبر الإنتروبيا، وهو مفهوم ديناميكي حراري يرتبط ارتباطًا وثيقًا بمقدار الفوضى في النظام.
تتميز الثقوب السوداء بخاصية مدهشة، إذ إن الإنتروبيا الخاصة بها تتناسب طرديًا مع مساحة سطحها، وليس مع حجمها. بمعنى آخر، ترتبط كمية المعلومات في الثقب الأسود بسطحه ثنائي الأبعاد، وليس بحجمه ثلاثي الأبعاد.
الإنتروبيا هي مفهوم في الديناميكا الحرارية يُعبر عن ميل الأنظمة نحو العشوائية. يوجد عدد هائل من الطرق التي قد يكون بها النظام في حالة فوضى، مقارنةً بعدد قليل من الطرق المنظمة.
جذب هذا السلوك الفريد للثقوب السوداء اهتمامًا كبيرًا، وبدأ كبار الفيزيائيين مثل ليونارد سسكيند في استكشاف مبدأ جديد أُطلق عليه اسم مبدأ الهولوغرام.
يشير الاسم إلى تقنية التصوير ثلاثي الأبعاد المعروفة، إذ تخزن المعلومات ثلاثية الأبعاد في سطح ثنائي الأبعاد يُظهر عمقًا وهميًا عند عرضه.
إذا كان هذا صحيحًا للثقوب السوداء، فقد يكون كذلك للكون بأكمله.
كون ثنائي الأبعاد:
قد لا يكون هذا الطرح غريبًا كما يبدو، إذ يوجد بالفعل مثال رياضي يعمل بموجب هذا المبدأ. يُعرف هذا النموذج باسم مطابقة (AdS/CFT)، وقد طُور عام 1997 على يد الفيزيائي خوان مالداسينا.
لفهم هذه المطابقة، تخيل كونًا خماسي الأبعاد أي ذا خمسة أبعاد مكانية، خال تمامًا من المادة والإشعاع، وتؤثر فيه قوة كونية تعمل على تقويسه نحو الداخل. يُعرف هذا النوع من الزمكان باسم فضاء دي سيتر المضاد.
عند محاولة حل مشكلة معقدة في هذا الكون، مثل فهم الجاذبية الكمومية، يمكن الاستعانة بنظرية الأوتار، وهي إحدى الأدوات النظرية المستخدمة في هذا السياق.
إن الجاذبية الكمومية هي فهم للجاذبية يُطبق على أصغر الأشياء في الكون، مثل الجسيمات دون الذرية. يمكن فهم سلوك هذه الجسيمات باستخدام ميكانيكا الكم، لكن عندما تشتد الجاذبية، كما هو الحال داخل الثقوب السوداء، تنهار النظريات. إن الجاذبية الكمومية هي محاولة لإصلاح تلك النظريات المعطوبة.
الحقول الكمومية هي كيانات تغمر الكون بأكمله. عندما تُنشط بقع من هذه الحقول، نرى نشوء الجسيمات أو تبادل القوى.
نظرية المجال المطابق هي نوع من نظريات المجال الكمومي التي تتميز بخصائص رياضية خاصة.
إن لهذه الأنواع من النظريات تطبيقات محدودة في بعض تجارب فيزياء الطاقة العالية، لكنها ليست مفيدة جدًا فيما سوى ذلك.
ما فعله مالداسينا كان مذهلًا، فقد حول المسألة داخل هذا الفضاء الخماسي إلى نظرية كمية في حدود رباعية الأبعاد خالية من الجاذبية، تُعرف باسم نظرية الحقول الكمومية الامتثالية.
هل تلك هي نشأة الزمكان؟
لم يتوقف الأمر عند هذا الحد. وسع بعض الفيزيائيين نطاق التصور ليشمل أصل الجاذبية نفسها، إذ اقترحوا أن التفاعلات الكمومية على حدود الكون قد تُنتج الزمكان داخل الكون نفسه. وهذا يشير إلى أن الزمكان -متضمنًا الجاذبية- ليس سوى إسقاط ناتج من ديناميكيات كمومية على سطح ثنائي الأبعاد.
إذا كان هذا صحيحًا، فإن ما يُرى كونًا ثلاثي الأبعاد مليئًا بالكواكب والنجوم والمجرات ما هو إلا هولوغرام، أي صورة ناتجة من فيزياء على حدود ذات بُعدين فقط، لكن ذلك يبقى مجرد احتمال.
رغم عقود من العمل في هذا المجال، فإن مبدأ الهولوغرافيا يعاني بعض العيوب:
أولًا إن تطابق (AdS/CFT) ما زال في هذه المرحلة مجرد تخمين حول ما قد يكون صحيحًا بناءً على بعض العلاقات الرياضية المُلاحظة، إذ لم يُثبت أحد صحة هذا التطابق فعليًا.
أيضًا فإن الكون الموصوف في المطابقة لا يشبه الكون الذي نعيش فيه إطلاقًا. يتألف الكون من ثلاثة أبعاد مكانية، وليس خمسة، ويحتوي على بُعد زمني.
إن الكون ليس فراغًا، ولا ينغلق على نفسه، بل إنه مملوء بالمادة والإشعاع، ويمر حاليًا بمرحلة من التوسع المتسارع. وأهم من ذلك، أن كوننا لا يملك حدودًا مُعرفة بدقة، ما يعني أن السبب الجوهري لوجود مبدأ الهولوغرام نفسه ينهار من الأساس.
ثانيًا، أكثر النظريات الفيزيائية التي تنطبق على المشكلات الحقيقية في الكون ليست نظريات مطابقة، من ثم لا تضمن الاستفادة من (AdS/CFT)، مع أنها وُظفت في بعض الحالات المثيرة للاهتمام.
مع أن مسألة المعلومات في الثقوب السوداء تظل مثيرة، فإن أحدًا لم ينجح في استخدام مبدأ الهولوغرام لوصف ما يحدث فعليًا للثقوب السوداء في الكون الواقعي، ناهيك بأن مفهوم (الإنتروبيا) في الثقوب السوداء لا ينطبق على الأجسام الأخرى، فإذا حشوت المعلومات داخل جسم، سترتفع الإنتروبيا بما يتناسب مع حجم الجسم، لا مساحة سطحه.
لكن هذا المجال ما زال في مراحله المبكرة، إذ استغرق الأمر أكثر من قرن قبل أن يتفق الفيزيائيون والكيميائيون على وجود الذرات، لذا من غير المنصف الحكم سريعًا على رؤى جديدة بالكاد بدأت تتبلور. لكن، ماذا لو وُجدت صلة وثيقة بين فيزياء الكون ثلاثي الأبعاد، والفيزياء الموجودة على حدوده الافتراضية؟
إذن هل الكون هولوغرام أم مجرد وهم رياضي؟
تظل تبعات مبدأ الهولوغرام غامضة إلى حد بعيد، فقد ذهب بعض الفيزيائيين إلى أقصى الحدود، وصرحوا بأن الواقع مجرد وهم، وأن ما يراه البشر من مكان وزمان وجاذبية ليس إلا تجليات لواقع أعمق يوجد في أبعاد أقل، وأن الكون هو هولوغرام بالكامل.
لكن الحلول الرياضية للنظريات الفيزيائية لا تعني بالضرورة أنها تصف الواقع، فيمكن اعتبار مبدأ الهولوغرام -حال ثبتت فائدته- مجرد أداة رياضية قوية -وربما ضرورية- لفهم الكون. لكن ذلك لا يعني أن ما تُخبر به الرياضيات هو حقيقة واقعية.
مثلًا، يستخدم الفيزيائيون باستمرار حيلًا رياضية متنوعة لحل المسائل المعقدة. أحيانًا تحول المشكلات إلى أبعاد أعلى أو أدنى، وأحيانًا تُترجم إلى أعداد تخيلية، وأحيانًا أخرى يُقلب الزمن إلى الأمام والخلف، ومن المعروف أن هذه الأساليب هي أدوات تحليل، لا تعبيرات عن البنية الأساسية للواقع.
لكن، في بعض الأحيان، تُرفع هذه الحيل الرياضية إلى مصاف النظريات الفيزيائية، وتُدمج في الفهم الأساسي للكون.
اقرأ أيضًا:
الهولوغرام الكمومي يصنع صورًا مفصلة لأجسامنا وخلايانا
للمرة الأولى ترميز المعلومات في هولوغرام باستعمال القفز الكمي
ترجمة: لور عماد خليل
تدقيق: نور حمود
الكاتب
لور عماد خليل